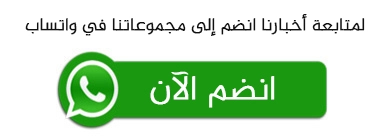متابعات الخبــــر الســــــوداني
لا تستغرب هذا العنوان عزيزي القارئ ….. إنها الحقيقة . لأول مرة أرى الحروف تستعصى على القلم ، و العبارات يحبسها الألم……
لا أدري رؤية منام أم أضغاث أحلام ساقتني إلى سبعةٍ و أربعين عامٍ إلى الوراء دون استئذان …. مسافات طويلة بقياس الأميال و الكيلو مترات ، و بعيدة بقياس الأيام و السنين و الساعات لكني مشيتها في أقل من ساعات ….
صدق أو لا تصدق و ربما لحظات …. ليس إسراء لأن الوقت لم يكن ليلاً ، و لم يكن لبشرٍ أن يسرى به بعد الحبيب محمد عليه افضل الصلاة و السلام ….. لأن سريانه كان روحاً و جسد و لغايات سامية تبقى مع البشرية إلى الأبد …… قد يسري الإنسان بنفسه سيراً أو بروحه ليلاً و يفرق في ذلك أن سريان السير محدود المسافات و محسوب الساعات و يكون اختيارياً . أما سريان الروح يتجاوز حساب المسافات و عداد الساعات و يكون إجبارياً …. إنها الرؤية المنامية ….. تأخذك حيث شاءت و متى شاءت ، قد تسعد بها و تتمنى لو أنها تمتد ، أو تشقى خلالها و تصيبك الهلوسة و القلق و تتمنى ما يخلصك منها ….
تلك التي ساقتني لسبعة و أربعين عامٍ إلى الوراء مع أن الوقت لم يكن ليلاً أو فجراً ….
أديت صلاة الفجر في بيتي على غير العادة بعد إخضاعي لعملية جراحية طفيفة في إجرائها و مطففة في آلامها و دوائها . و اجبرتني التزام الكرسي في كل الصلوات و منعتني وردي اليومي من القرآن ……
صليت هذا اليوم و تناولت الدواء ( المسكِّن ) للألم و تصفحت الهاتف على عجل ثم خلصت إلى النوم و منبه الهاتف يرسم على الشاشة ( شروق الشمس )…….
دائماً يثقل علي النوم بسبب المسكِّن فتذهب معاناة الألم لكنها لمكان قريب تترقب انتهاء مفعول المسكِّن لتقوم بواجبها الطبيعي ! …..
في خلال هذه الغفوة الزمنية تسللت روحي خلسة دونما أشعر ( اللهُ يَتَوفَّى الأنْفُسَ حِينَ مَوتِها و الَّتِي لمْ تمُتْ في مَنامِها فيُمسِك التي قضَى عليها الموتُ و يُرْسِل الأُخْرى إلى أجَلٍ مُسَمَّىً ) …..
سرت روحي من مصر إلى السودان …. من غير تأشيرات مرورية … و دون المرور بنقاط حدودية …. متجاوزة كل الأعراف و المواثيق الدولية …. متحديةً كل الحدود الإقليمية لتحط بي عند بقعة تجاوزتها بعامل السنين و الأزمان لكنها بقيت خالدة في القلوب و الأذهان لأنها كانت جزءاً أصيلاً من تكوين شخصيتي و بناء ذاتي ….
إنها مدرسة خور طقت الثانوية العليا بمسماها السابق و ما أدراك ما خور طقت !!!! …
وجدت نفسي فيها صبيحة هذا اليوم أتجول في فنائها مع أشخاص لم أعرفهم و أول ما مريت بهم على داخلية أبوسن التي كنت رئيسها المناوب عام ١٩٧٨م …. ثم دلفت أعرف مرافقي على داخلياتها واحدة تلو الأخرى( زاكي الدين ، ابو عنجة ، تكتوك ، ود زايد ، الولي ، ود التوم ، ود دوليب ، ود ضيف الله ، علي دينار ) إلى ردهات الطعام حيث كنت عضواً في لجنة الطعام للإشراف على نوعيته و جودته و كانت لجنة الطعام هي التي تحدد نوعية و ضبط جودة الطعام و لها كامل الصلاحية في قبوله أو رفضه ….
وجدت المدرسة خافرة من المرتادين سواء كانوا طلاب أو معلمين أو عمال و تعمرها أشجار كثيفة . لكني كلما مريت على موطئ تذكرت فيه حادثة ….
طفت مع مرافقي صحن المدرسة معرفاً إياه بالمسرح و قاعة و مدرج الاجتماعات الذي يسع لألف طالب و أكثر و المكتبة و المعمل و شعب العلوم المختلفة و (سبحان الله) وقفت معهم عند سوق ( عكاظ ) و هو ممر تعلق فيه الإعلانات اليومية و يحفل بالكتابات الأدبية و الإجتماعية و السياسية التي كنا نسمي الواحد منها ( اللهيب ) و شرحت لهم كيف كنا نتسابق للصق منشوراتنا في الصباح الباكر و كيف كنا نتزاحم على قراءة هذه المنشورات قبل أن ينتزعها الفراشون بأمر من إدارة المدرسة و الجهات الأمنية…… وقفت عند فصل ( علي ) الذي درست فيه الصف الثاني و ( الرشيد ) الذي درست فيه الأول و ( المتنبي ) الذي درست فيه الصف الثالث و من ثم أشرت إلى قاعة الفنون فقلت لهم سبحان الله : هذه القاعة التي كان يدرسنا فيها الاستاذ النور حمد ( مادة الفنون ) ، و مخزن أسلحة (الكديت) و قلت لهم قد تم تدريبنا على السلاح من هذا المخزن . و سرنا قليلاً إلى الشرق و قلت لهم هذا منزل مدير المدرسة كان يسكنه الأستاذ عبد الحميد محمد مدني مدير المدرسة رحمه الله و تلك منازل المعلمين . و طفت من ناحية الشمال حيث ميدان ألعاب القوة و بجوارها مكتب المدير الأستاذ إبراهيم آدم الدين الذي أسسه بنفسه بدلاً عن مكتب الإدارة العريق لما فيه من سعة . و نَصَب عليه طاولة اجتماعات باللون الأزرق لعله كان يحبذ لبسه لأنه كان يتميز بغالب زيه الأزرق له المغفرة و الرحمة ….
في تجوالي مررت على (كنتين) المدرسة و دكان الحلاق و وقفت عند عربات الترحيل ( الكومر ) و ( قدُّوم قصِّير ) التي كانت تقل المعلمين و المرضى المحولين للعلاج من الطلاب بمستشفى الأبيض . و بدا لي كذلك البوفيه بسوره من مواسير الحديد مدهونة باللون الأخضر و التفت فبدت لي كل جملونات و أسقف الفصول ب ( مروق ) الخشب كلها مدهونة باللون الأخضر حتى أبواب الفصول و المكاتب و هي أصلاً كانت كذلك أن لم تخني الذاكرة ….
في هذا الأثناء دخلت في حوار مع أحد المرافقين و كأنه السائق فقلت له :
نرجع في طريقنا إلى الأبيض بقرية الدونكي و هي قرية خور طقت الأصلية و سميت بالدونكي لوجود دونكي الماء بها و اسم خور طقت نسبة للخور الموسمي الذي يمر عبرها من الجنوب إلى الشمال محملاً بالمياه وقت الخريف . و هو رافد من روافد خور (ابو حبل) المشهور وذلك لتلقي نظرة على التبلديات التي كنا نتسلقها و نستظل بظلها . و غابة الهشاب التي كنا نرتع (صمغها) و نختبئ عندها بعيداً عن رقابة المدرسة حال تمردنا على الدروس و منا من له (مآرب) أخرى في الدونكي يعلمها خريجو خور طقت و اللبيب بالإشارة يفهم !…. رفض السائق مقترحي و أصر على الرجوع عن طريق (الردمية) لأنه أقرب مسافة وخالٍ من الحفر ….
حدثت بيننا مشادة في الحديث و دونما أشعر ركلته برجلي التي عليها العملية فأفقت من نومي على ألم لم أستطع وصفه و لم أفق منه إلا بعد نصف ساعة من معناة الألم و تناول المسكِّن و انتبهت إلى الزمن فوجدت أن الساعة قد أشارت إلى التاسعة صباحاً و عرفت أن رحلتى كانت (ضحوة) منامية حاولت تدوينها مع اعتصار الألم و استعصاء الحروف و استعصام العبارات فخرجت بهذا المقال مع جرة القلم و شدة الألم …..
و يا لها من نقطة فيحاء
في أفريقيا البلد العريق
من طقت الكبري سأهتف
معلناً هذا النشيد
هذا النشيد الحلو
رمزاً للسلام و للخلود …
هذه ابيات مقتطفة من نشيد خور طقت الذي كنا ننشده في كل المناسبات الثقافية و المهرجانات ….
و لله در أيام كانت قضيناها
و ما زالت في القلب ذكراها ….
الغالي الزين
٢٠٢٥/٢/١٦م